الأستاذ حسن ساباز: الكمالية
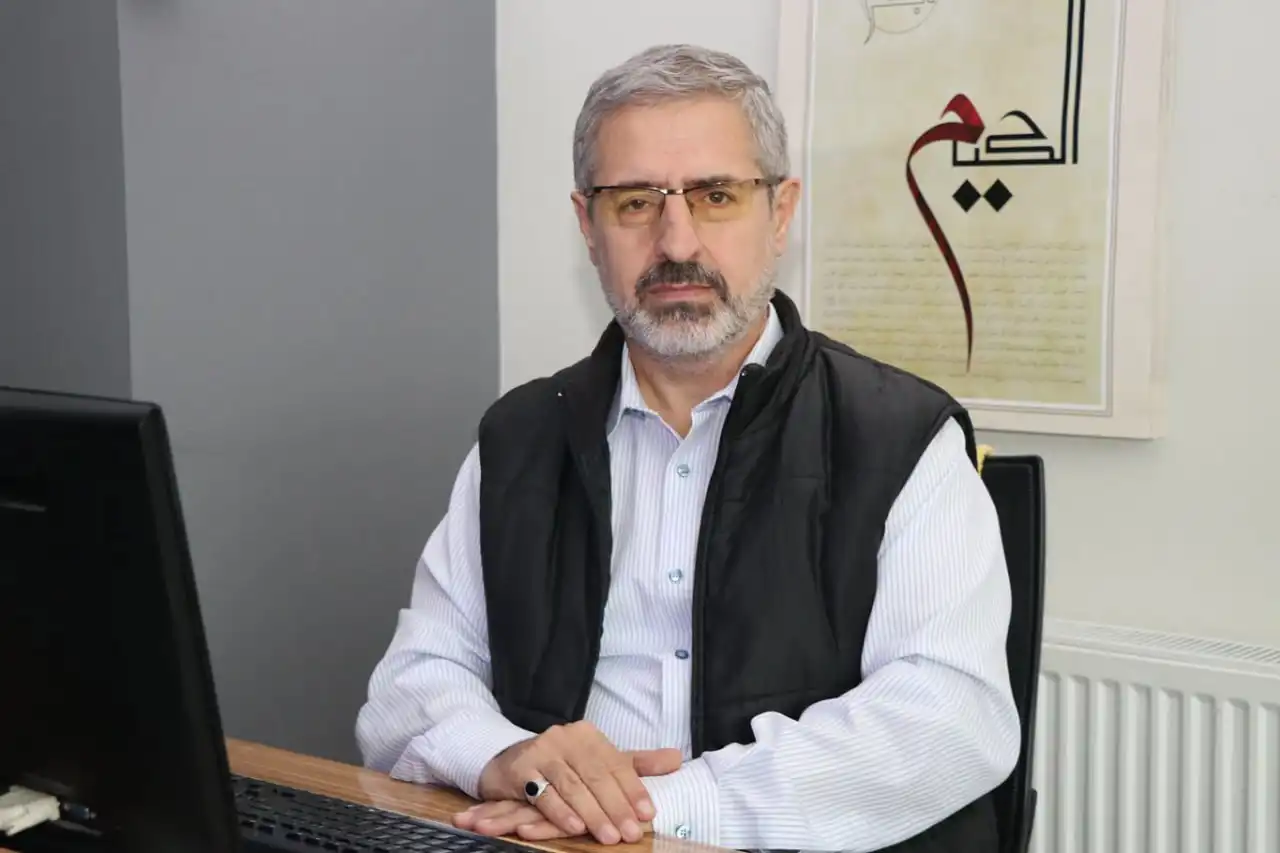
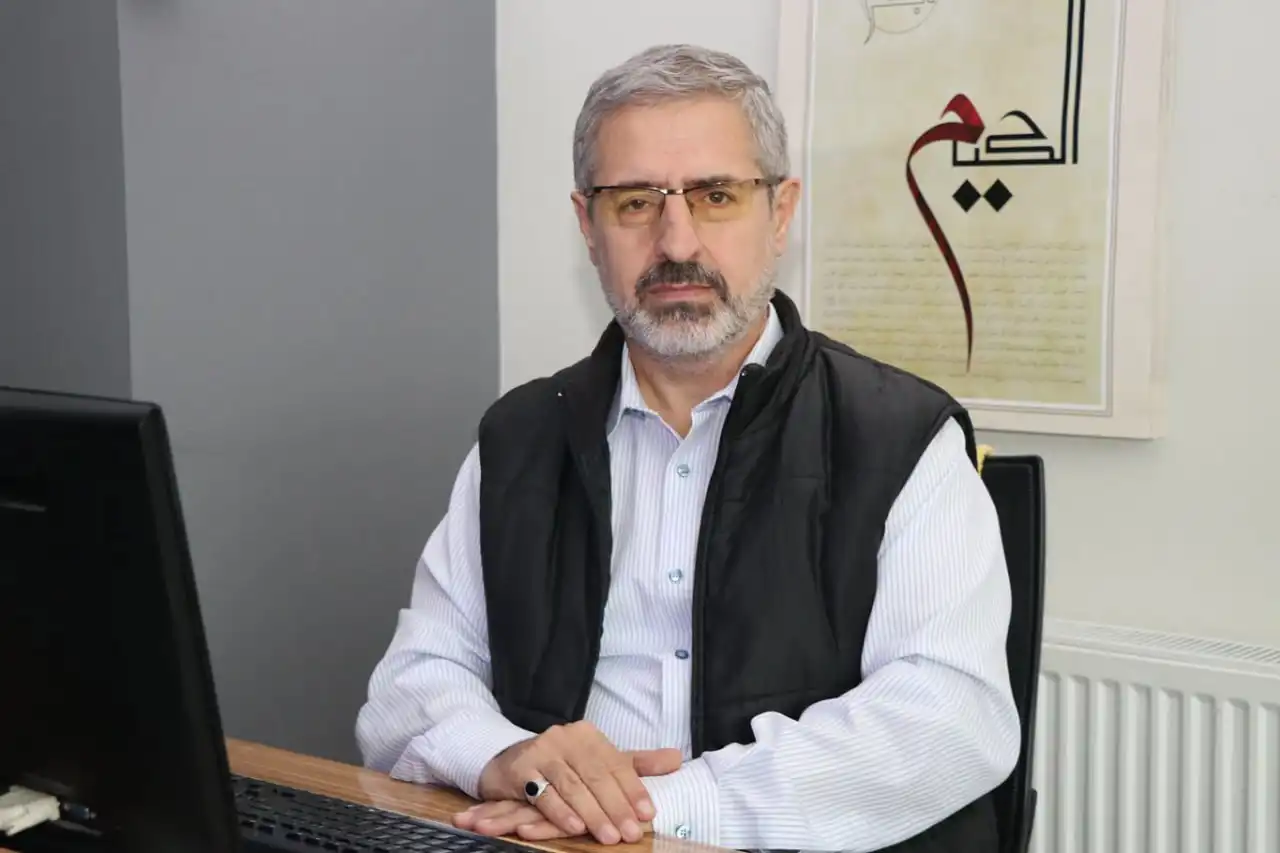
يبين الأستاذ حسن ساباز أن الخطاب التركي تجاه الكمالية شهد هذا العام تحولاً واضحًا؛ إذ تقلّص النقد واتسعت دائرة المبرّرين والمدافعين عنها، حتى من بين من كانوا ينتقدونها سابقًا، ويؤكد أن الجدل حول ماهية الكمالية ما يزال غامضًا ومتضاربًا، بين من يعتبرها مشروعًا تحديثيًا ومن يصفها بدين سياسي لا يزال تأثيره حاضرًا بقوة.
كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:
شهدت تركيا هذا العام مشهداً غير مألوف خلال فعاليات إحياء ذكرى 10 تشرين الثاني/نوفمبر؛ إذ وجد المتديّنون أنفسهم أمام فئة أكثر حدّة وتشنجًا من المعتاد، في مناخ يدل بأن النقاش حول الكمالية لم يعد كما كان.
فبعض الشخصيات التي ألّفت في الماضي كتباً تنتقد ممارسات الكمالية، وجدت نفسها ضمن «جوقة الترحّم» على أتاتورك، كما انخرط في الموقف ذاته ممثلو أحزاب سياسية متباينة المواقع.
ومع تصاعد الاتهامات التي تشير إلى عداء الكمالية للإسلام، لجأ عدد من أساتذة الإلهيات إلى استحضار تصريحات مصطفى كمال في عشرينيات القرن الماضي للردّ على هذه الاتهامات، مقدّمين صورة توحي بأن «أتاتورك كان يجلّ الدين ويحترمه». وفي هذا السياق، بدا إعلام الحكومة وكأنه يسارع للدفاع عن أتاتورك، في محاولة لاستيعاب المدّ الكمالي الجديد داخل المنظومة الحاكمة.
هكذا طويت صفحات الحقبة الحزبية الواحدة وكأن شيئًا لم يكن، وارتفع الصوت القائل بأن مصطفى كمال «قيمة وطنية مشتركة». وفي المقابل، لم يُخفِ الكماليون ارتياحهم، بل عبّروا صراحة عن عدم تغيّرهم، وعن حنينهم المتجذّر لثلاثينيات القرن الماضي.
قبل سنوات، كان الجدل الدائر يتمحور حول ماهية الكمالية: ما هي وما ليست هي؟ أمّا اليوم، فقد تجاوز النقاش ذلك تمامًا؛ إذ بات يُفترض بالجميع قبول التعريفات التي يطرحها أصحاب السلطة، بما ينسجم مع الجوهر الروحي للكمالية ذاتها، القائمة على فرض القراءة الرسمية على المجتمع.
وفي خضم ذلك، ظهر من واجه حرجًا في «المناورة»، كما برز آخرون استمرّوا في التعبير عن نقدهم للكمالية بثبات وشجاعة، ولدى مراجعة تلك النقاشات، برزت أمامنا معلومات لافتة.
ففي مقال نُشر عام 2019 بعنوان «الكمالية دين الأتراك»، يذكر الكاتب محمد دوغان أن الطبعة الأولى من معجم اللغة التركية عام 1945 ضمّت عبارة: «الكمالية دين الأتراك» تحت مادة «الدين»، رغم وصفها بأنها «مجاز». ويعلّق دوغان بأن الوقائع التاريخية تجعل هذا الوصف أقرب إلى الحقيقة، ومع مرور الوقت، استُبدل التعبير بـ«الأتاتوركية دين الأتراك».
وعلى نحو مشابه، يستعيد أونور أطالاي في كتابه «العبادة عند الأتراك» دور الروائي يعقوب قدري قرة عثمان أوغلو الذي اعتبر الكمالية «مذهبًا» في استفتاء لصحيفة «ملّيت» عام 1929، ثم عاد عام 1931 ليستخدم عبارة «طريقة الكمالية»، مؤكداً ضرورة قدرة هذه «الطريقة» على «إيقاد نارها في أقسى القلوب ظلامًا».
أما النقاش حول علاقة الكمالية بفكر البعث، فقد شهد بدوره آراء متباينة، فبينما يرى أمره آكوز أنّ الكمالية متوافقة مع الرأسمالية لكنها احتوت داخلها عناصر «بعثية التفكير»، يقول أنيل تشجن إن غياب التشابه بين الكمالية والبعث يعود إلى اختلاف ظروف النشأة ونماذج الدولة، وفي المقابل يؤكد ياووز ألوغان أن التشابه يصل إلى حد التطابق؛ فكلا المشروعين أسّسا لبناء دولة قومية مركزية، وتنمية اقتصادية واجتماعية، وتعليم جماهيري، وعَلمانية جذرية، لافتًا إلى أن «قومية البعث هي ابنة الكمالية».
هذه التناقضات في توصيف الكمالية ليست استثناءً بسيطًا؛ بل تعكس حقيقة أن الكمالية، رغم كونها مطروحة باعتبارها «أيديولوجيا»، تملك طبيعة أكثر تعقيداً من أن تُختزل في قالب فكري واحد، فهي في نظر البعض مشروع تحديث، ولدى آخرين منظومة سلطوية، وعند فريق ثالث «دين سياسي» قائم بذاته.
هنا يبرز السؤال الجوهري الذي لا يبدو أن الكماليين يرغبون في الإجابة عنه بوضوح:
هل الكمالية دين؟
أم مذهب؟
أم طريقة؟
أم خليط يتجاوز هذه التصنيفات جميعًا؟
وحتى يحسم الكماليون أمرهم، سيظل الجدل قائمًا وسيظل فهم الكمالية مرهونًا بمن يكتب عنها لا بمن أسّسها. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
يوضح الأستاذ نذير تونتش أن الأكراد في تركيا يواجهون محاولات محو لغتهم الأم ضمن سياسات رسمية للتتريك، وأن الخطوات الرمزية مثل دروس اللغة الكردية والبرامج التلفزيونية لا تكفي.
يسلط الأستاذ محمد كوكطاش الضوء على قسوة البرد الذي اختبره شخصيًا، ويقارن مع معاناة أطفال غزة الذين يواجهون الشتاء بلا مأوى أو تدفئة، محذرًا من تقصيرنا الإنساني والديني تجاههم.
يسلط الأستاذ محمد علي كونول الضوء في ذكرى وفاة سزائي كاراكوتش على إرثه الثقافي والفكري ودوره في إثراء جاغالوغلو بالحضارة والفكر، مستذكرًا تأثيره العميق على محبيه والمجتمع الثقافي.